حين تتحدثُ الصّورةُ فابحثْ عن أصواتٍ متواريةٍ في زواياها. -كي تبقى تلك المرايا خالدة- قد تكون قوام ذلك الصرح في بحثك،ثم تتكسر؛ لتنشئ صرحا آخر من خلال المرايا ذاتها. الحديثُ هنا باعتبار الصّورة قولا؛ لهذا هي تدور في المدارات الجاكبسونية السّتة التي ذكر منها حازم القرطاجني أربعة: ( المرسل، المرسل إليه، الرسالة، السياق، الشفرة والوسيلة).
في “مرايا” مساحاتٌ يسبحُ فيها الناقد. فيؤطر العقد النّاظم لمجموعة لوحاتٍ كمرحلة تاريخية أو رؤية فكرية منبثقة من اللاتاريخ في ذهنية الصناعة المنتجة، أو حتى لمجموعة اللّوحات ككلّ. قد يتأمل قارئ في خيط ناظم للوحات مرايا فيجد ارتكاز النص على رسالةٍ يريد الإخبار بها، فضلا عن من يتحدث عن لوحة على حدة، لكن هل رؤية السطح شاقةٌ لدرجة الكتابة عنه؟! سؤال يستدعي الجِدَ في تأمل كثير مما يطرح من نقد! هنا أتأمل في حركة لوحتين من مرايا وهما: “الموعد” و”الورقة الخضراء” ابتداء من ارتكازية اللّوحات لتتأسّس ذاتيا، وحتى تفككها الذاتي لترتبط مع أخريات في منظومة قولية واحدة كبرى.
سأنطلق من تساؤل: هل أنّ التحول اللّغوي إلى الصّورة يلزمه بالضرورة تحول جذري في التّلقي؟ إذا انطلقتُ من المخطط الجاكبسوني سأقول بكل بساطة لا؛ لأنّ الاستعمال النفعي موجود أيضا في ثقافة الصورة. فحين تنتهي اللوحة في مرايا هل ينتهي دورها كما ينتهي دور أيّ رسالة قُدّمتْ لنا لتخبرنا عن أمرٍ ما، أم أن دور اللوحة يُرْجئ المتلقي إلى لوحة أخرى؟ إذ تدعوه للبحث عن أختها، فهي تنحرف عن خط الرسالة العادية جاعلة المتلقي والرسالة وصاحبها ينخرطون في داخل اللوحة فيتجاذبونها مما يضمن ذلك الإرجاء النصي. فاللوحة غاية بذاتها لها عالمها الخاص، وهي في الوقت ذاته تفكّك مدلولاتها لتنظمَّ مع أخرياتٍ لتصب دوال تبحث عن مدلولات وهكذا.
لوحة “الموعد” تستدعي الأسطورة دون أن تفصحَ عن ذلك. فهي أولا تحكي قصة الصانع “مسلّم” الذي أرسله معلّمه؛ ليأتي له بغداء من عند اللحام، فغاب دقائق. ثم عاد يَرْجُف من شدة الخوف ويصرخ طالبا أن يخبئوه من رجلٍ منظره غريب ومخيف جدا! نظر إلى مسلّم نظرة تعجبٍ تقدح شررا ورعبا مليئة برائحة القبور! فطلب من معلمه أن يعيره حصانه؛ ليهرب به خارج الشام ذاهبا إلى أهله في ضيعة “حوش خان” وهي بعيدة عن الشام، كما قال له معلمه: “لن تصل إلا بعد العشاء”. ثم ذهب المعلم إلى اللحام ليأتي بالغداء بدلا من مسلّم، وهو في الطريق قابل الرجل الذي أخاف مسلّم، فسأله : “مو أنت اللي باعثينك تراقب صانعي مسلّم، وتقتله، وتأخذ روحه؟” فردّ الرّجل: “نعم بالضبط! وأنا ما أقدر أخدمك اليوم، لكن بيجي اليوم اللي بقدم فيه خدماتي لك. وهلّا شو بدك مني؟” فردّ: “ليش تهدد مسلّم بالموت؟ المسكين جاء للدكان خائف، وكأنّه شاف الموت بعيونه؟ فردّ الرجل: “بالعكس تماما، أنا لما اطلّعْت بمسلّم ما في بعيوني أي معنى للتهديد! إنما كانت نظراتي نظرات تعجب واندهاش؛ لأني ما كنت متوقع شوفه بالظهر بالشام. أنا عندي موعد معه بالمساء لأنهي المهمة المكلف بها هنيك بضيعته خوش خان!”.
تحولت اللوحة إلى نصٍ حين حلّت في السياق وهو أكبر منها. وهو هنا ذلك الرصيد الذهني لحضارة طويلة تمثلتْ في أسطورة سليمان القائلة أن ثمةَ وزيرا عند النبي سليمان جالسا، فدخل رجل وجلس عند سليمان يحدثه ويخزّ ذلك الوزير بعينيه، ففزعَ الوزير. فلمّا خرج ذلك الرّجل، سأل الوزيرُ سليمانَ: “من هذا ؟ قد أفزعني منظره!”. فقال سليمان :”هذا ملك الموت يتصور بصورة رجلٍ، ويدخل عليَّ.” ففزع الوزير وبكى. وقال لسليمان: “أسألك بالله أن تأمر الريح فتحملني إلى الهند. فأمر سليمان الريحَ فحملته! فلما كان من الغد دخل ملك الموت على سليمان يسلّم عليه، كما كان يفعل فقال له سليمان: “قد أفزعتَ صاحبي بالأمس فما بالك؟” فقال: “يا سليمان إني دخلتُ عليك في الضحى. وقد أمرني الله أن أقبضَ روحه بعد الظهر في الهند! فعجبت أنه عندك.”
إلا أن النص هنا في مرايا لم يقع ضحية هذا السياق وتحت لوائه، منغمرا في بحاره! حين استعانَ بشفرة (إنزال السياق – بقوة الصورة وهيمنتها الثقافية – إلى الأرض). فالوزير = العامل، والنبي سليمان = مدير العمّال، وملك الموت = قاتل يمشي بين الناس في الأسواق ويأكل أكلهم. وهذا ما جعل النصَ متميزا في ذاته. فليس النص هنا “مُخْبرا”، إنما جاوزه إلى ارتعاشةٍ جمالية، أوقعتْ لذةً وألما في نفس المتلقي؛ لأنه حصل لها علم وجهل في الآن ذاته؛ فهي تتساءل: “ثم ماذا ؟” وهنا تلتقي الصورة بالتعبير اللفظي بالعبارات المجازية التي هي ألذ من التعبير بالألفاظ الحقيقية، إلا أنّها تعدنا عند شارة النهاية أنها ستفكك ذاتها لتتحول إلى دالّ يبحث عن مدلول (فالقاتل أشار برأسه قائلا: “هنييك في خوش خان”). وهذا يؤكد انفتاح دلالة العنوان “الموعد”.
تميزُ الذاتِ هنا قد يكون طريقا للتحول في نطاق الصورة التي ما فتئت تنقل ما دُوِّن في الأوراق فحسب. فهذا التحول الذاتي سيتطور فنيا مؤثرا على السياق التقليدي، ويَحْرِفه إذا تضافرت معه فعالية نصوصية، مما يضمن تحولّه إلى حركة جماعية. وهذا يدخلنا إلى اللوحة الثانية: “الورقة الخضراء”، التي جمعت صديقا بصديقه ليخبره أنه اجتمع مع سائحة يونانية عالقة بورطة من زيادة وزن شحنها. وحلَّ لها المشكلة “بدون ما يدفّعها ولا ليرة” وشكرته بطريقة غريبة – كما يقول – “فتحت شنطتها وأخرجت ورقة صغيرة. وكتبت له وحطتها في ظرف وأعطته إياه”. خرج الصديقان إلى كل من يعرفان أنّه يفهم اللغة اليونانية، وكلّ واحد يسبهم ويشتمهم ومن ثم يطردهم. حتى “راحوا للسفارة اليونانية نفسها”. جلسا ينتظران في الخارج فخرج لهما الحارس قائلا: “بيقول لكم القنصل إذا بتقربوا هنا مرة ثانية بدّوا يكسر رجلكم”. فسألاه عن الورقة؟ قال: “من كثر ما ا نحرق بدنه، أحرقها بالقداحة وكبّها بالزبالة.” انتهت اللوحة.
التقاء هذه اللوحة بلوحة “الموعد” في الألم واللذة التي يشير إلى بعضها الرازي في قوله “فهو أن النفس إذا وقفت على تمام المقصد لم يبقَ لها شوقٌ إليه أصلا؛ لأن تحصيل الحاصل محال. وإن لم تقف على شيء منه أصلا لم يحصل لها شوق إليه. فأما إذا عرفته من بعض الوجوه دون البعض، فإنّ القدر المعلوم يشوقها إلى تحصيل العلم بما ليس معلوما. فيحصل لها بسبب علمها بالقدر الذي علمته لذة. وبسبب حرمانها من الباقي ألم، فتحصل هناك لذات وآلام متعاقبة. واللذة إذا حصلت عقب الألم كانت أقوى. وشعور النفس بها أتمّ”. إلّا أنّ لوحة “الموعد” شددت على السياق في ذاتها، تصنع له المتعة حتى النهاية. وأرجأت الألم بعدها في إحالة للمتلقي بتفكيك ذاتها والبحث عن أجوبة في أماكن أخرى. ولوحة “الورقة الخضراء” شدّدت على المتلقي في ذاتها، لمزيدٍ من الألم، حين جعلت الإجابة في ذاتها. ومن ثمّ تصنع الروابط بعيدا. فقد ينفتح أفق المتلقي –بناء على المعاملة الحسنة من هذا الرجل مع السائحة وسوء أخلاق من يعمل في المطار وغيره – على أن مضمون الورقة هو: “حامل هذه الورقة يحمل من الأخلاق ما لا يحمله أهل البلد، فقد برز سوؤهم حين عشت بينهم.” لهذا كلّ يطرده. ولكن حتى القنصل طرده، بل أحرق الورقة فيخيب أفق المتلقي فتزداد حسرته.
لنتأمل ثلاث علامات. الأولى: في العنوان “الخضراء” والثانية:صاحبة الورقة من “اليونان” والثالثة: “الحرق”. العنوان فيه خبرٌ يحمل صفة “الخضراء”. لماذا ليست الحمراء، أو الصفراء …إلخ؟ ثم نتفاجأ بأن صاحبة الورقة “يونانية” فلماذا ليست فرنسية؟ أو ألمانية؟ أو بريطانية؟ أو..إلخ؟ وانتهت اللوحة بحرق الورقة من قِبَل القنصل “اليوناني”. لدينا (امرأة) من (اليونان) ولدينا (مقر) سياسي لليونان. ويقابل ذلك السوريون بردة فعلهم. فالورقة تتضمن اللقاء بين الثقافة العربية والثقافة اليونانية، من خلال رمزية (الأخضر) وبينها من خلال رمزية (الحرق) ومن داخلها استدعاء التاريخ للمثول بين يدي الصورة.
أولا، يُذكر أن غزو الإسكندر المقدوني للشرق كان الطريق الممهد لانتقال الفلسفة اليونانية إلى الشرق الأدنى. وحنا الفاخوري وصديقه في كتابهما “تاريخ الفكر العربي عند العرب” يقولان: “إن السوريين اتصلوا بالثقافة اليونانية قبل طريق الإسكندرية.” ثانيا، يُروى أن عَمْرو بن العاص حين دخل الإسكندرية وجد فيها خزانة كتب. فاستشار عمر بن الخطاب في أمرها فقال له: “إن كان فيها -أي الكتب- ما يوافق كتاب الله ففيه غنى عنها. وإن كان غير ذلك فلا حاجة فيها فتقدَّم بإتلافها. فأخذ عمرو في تفريقها على حمامات الإسكندرية وإحراقها. في الرواية، العربُ من يُحْرِق. وفي اللوحة: اليونانيّ من أحرق. الحرق ُ كان ذروة الفعل، إذن ردة الفعل واحدة في اللوحة.
فهل اللوحة مستبطنة التكذيب، بإظهار رؤية متوازنة من حيث دلالة الأخضر أولا واختصاصه بالمرأة اليونانية، في دلالاته المستهلكة حيث يبعث الحب والسلام. ومن ثم دلالة الحرق واختصاصه بالسياسي اليوناني. في مقابل رواية عمرو بن العاص حيث تأخذ دلالات سياسية، ودلالة الانتصار في سطح اللوحة للروح المتعددة في العرب. إذ لم تنكر اللوحة الفعل العربي بتمامه، وتنزهه بشكل ساذج. فلم تعتمد على إنكار بعض الباحثين لرواية حرق عمرو للمكتبة ومنهم ماكس مايرهوف إذ يرفض أن يكون المسلمون قد أحرقوا مكتبة الإسكندرية. ولكن وازنت عن طريق الحكاية التي تستبطن رموزها في ذاتها.
ولتستمر اللوحة في إنبات دلالاتها؛ حيث التكامل اللوني في دائرته: الأحمر يكمله الأخضر وأعلى لون في علم سورية الأحمر، والأحمر في بعض حالاته يرمز للدم والقتل والنار المحرقة والغضب الشديد. ومن حيث تخفيف حدة اللون الأحمر يستعان بالأخضر. وإذا انتقلنا إلى علم اليونان نجده مكونا من تسعة خطوط أفقية؛ يُشار أنها بعدد مقاطع جملة يونانية ترجمتها “الحرية أو الموت” وهذه كلمة تصلح أن تكون عنوانا للوحة. وبحسب نظرية أخرى فإن تسعة في العلم هو عدد آلهة الإلهام، فالـ”الخضراء” رمز للإلهام. مما يعني أن الورقة حملت نصا عميقا كتلك التي تحملها النصوص الإلهية أو العابرة للأزمان. وردات الفعل كانت موازية لتلقي أتباع الأديان لتلك النصوص.
وبعد، ففاعلية اللون -في كل لقطة ومشهد في اللوحة – ودلالته الجمالية ووظيفته إذا التُقط من خلال اختلافات السياق ستنتج مقدمات مغايرة، ستفتح أفقا ينبع من اللوحة ذاتها. إذ إنّ السياق هو الذي يحدد دلالة اللّون من خلال تفاعل الدلالة اللونية مع دلالة المشاهد المجاورة لها في السياق الأكبر فالأكبر. وحينها لن نعتبر اللون ظاهرة بصرية فحسب وإنما جاوزناه إلى دلالة جمالية وذهنية ونفسية ووجدانية، إضافة إلى دلالات أخرى سيثيرها اللون نفسه عندما نستبدل السياقات.
وحينها يُخْلق الدّال من المدلول، بعد أن أنجب الدال مدلولا.

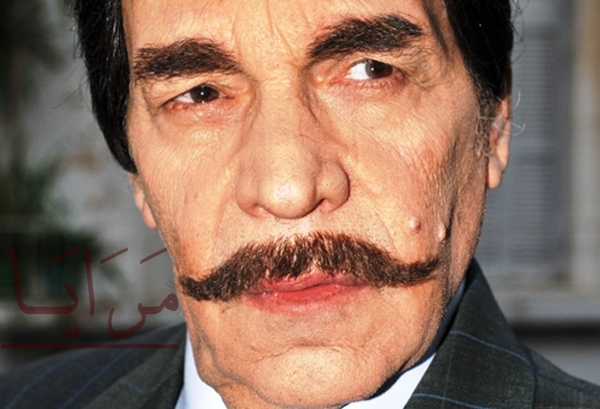




اضف تعليق